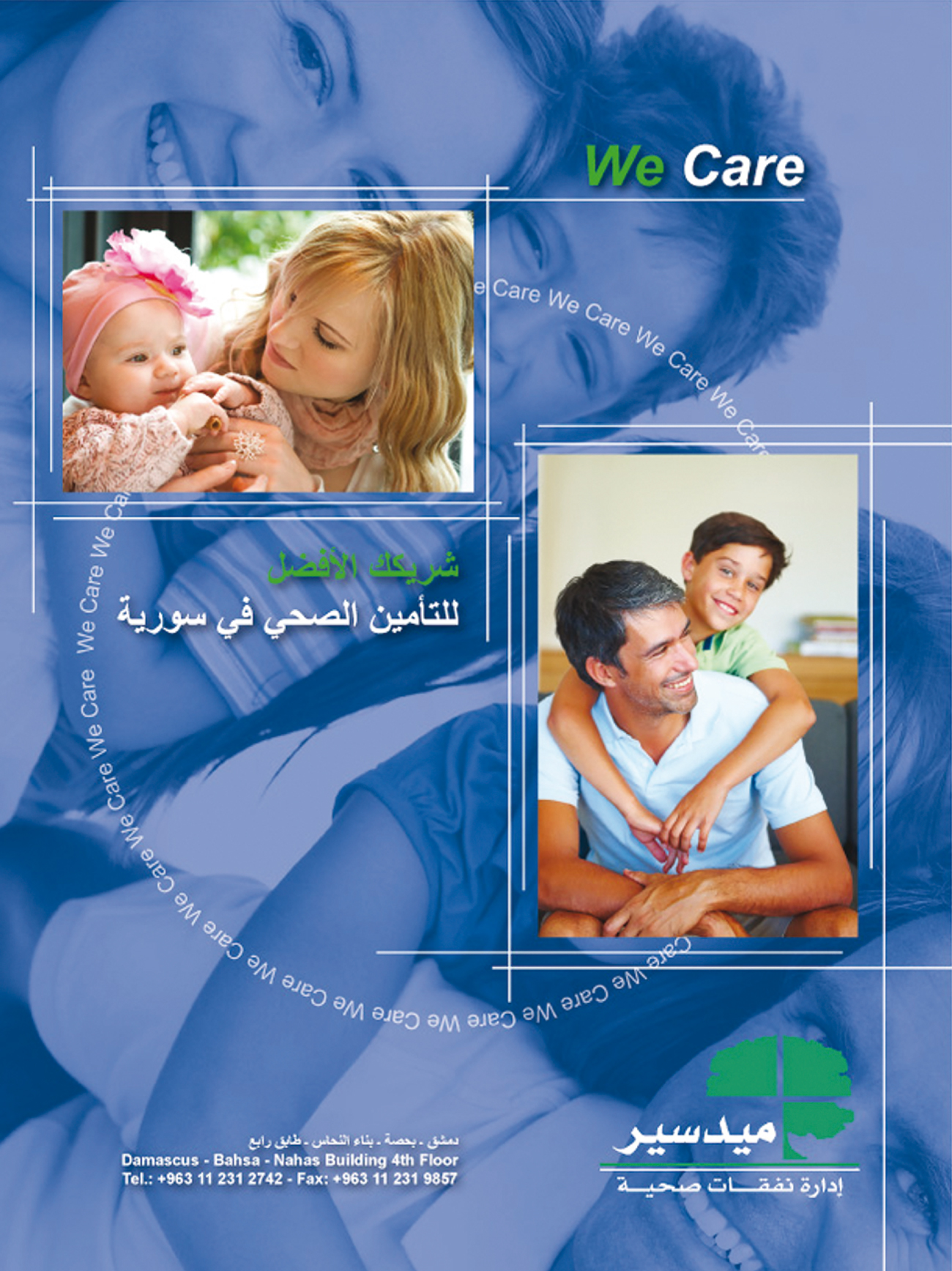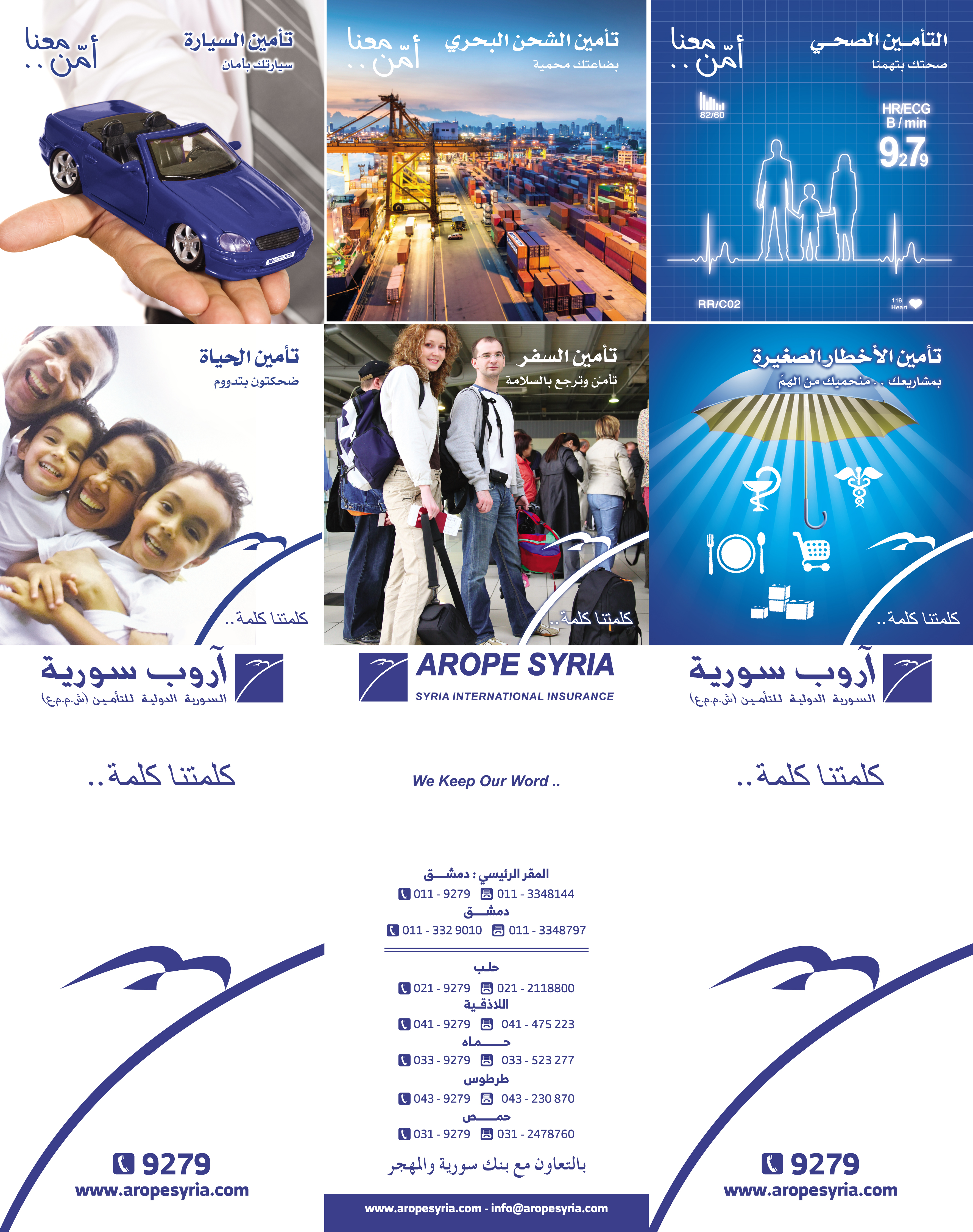مقدمة في قياس الخطر وإدارته
من كتاب الخطر والتأمين
المؤلفان د.مختار الهانسي
د.أسامة عبد العزيز
يختلف مفهوم الخطر بالنسبة للفرد والمنشأةعن مفهوم الخطر بالنسبة لشركات التأمين, وعلى ذلك يختلف أسلوب تقدير حجم الخسائر المتوقعة في الحالتين.
فالفرد ( أو المنشأة ) ينظر إلى الخطر على أساس أنه الخسائر المادية الاحتمالية نتيجة وقوع حادث معين, فالفرد المعرض لخطر السطو أو السرقة إنما يتوقع خسائر مادية إذا ما وقع حادث السطو أو السرقة ,وهو بذلك يلجأ إلى إحدى الطرق المتعارف عليها لحماية نفسة ومواجهة هذا الخطر (وقد يكون ذلك من خلال الإلتجاء إلى أسلوب العمل التأميني)
أما بالنسبة لشركات التأمين فالأمر يختلف في مفهومها للخطر, حيث أن شركة التأمين هي إحدى هيئات مواجبة الخطر والطرق المستخدمة في رد الخسائر ودفع التعويضات, لذلك يتمثل مفهوم الخطر لديها في الفرق بين كل ما هو مخطط وما تم تحقيقه فعلاً وذلك بالنسبة للحقوق والالتزامات.
وعلى ذلك سنتعرض لكيفية قياس الخطر وإدارته سواء على مستوى الفرد (المنشأة) أو على مستوى شركات التأمين .
أولاً: كيفية قياس الخطر:
الحالة الأولى : قياس الخطر من وجهة نظر الفرد والمنشأة .
قياس هذه العوامل كمياً:
ويمكن تحديد أهم هذه العوامل في ثلاث:
أ -قيمة الأشياء المعرضة للخطر
ب - عدد الأشياء المعرضة للخطر
ج – معدل الخسائر المتوقعة
وإذا استطعنا قياس أثر كل عامل من هذه العوامل على حجم الخسائر المادية الاحتمالية ( الجانب المادي للخطر ) يمكننا تحديد الأثر العام على حجم هذه الخسائر.
أ- القيمة المعرضة للخطر:
وهي ليس بالضرورة أن تتساوى مع القيمة الكاملة للشيئ موضوع الخطر, حيث يمكن تقديرها بأقصى خسائر مادية ما يمكن ان تحدث للشيئ موضوع الخطر عند وقوع الخطر للشيئ المعرض له ,هذا حالة الممتلكات, أما في حالة تأمينات الحياة فيكون ذلك من خلال المجموع الكلي للأعباء والمصروفات الضرورية بعد وفاة الشخص وهذا يعبر عن مبلغ التأمين واجب السداد على فرض أن الوفاة ستحدث حالا.
والعلاقة هنا طردية بين قيمة الأشياء المعرضة للخطر و قيمة الخسائر المادية المحتملة والممثلة للخطر.
ب- عدد الأشياء المعرضة للخطر:
يجب أن تكون هذه الأشياء مستقلة عن بعضها البعض ومن المعروف أن العلاقة هنا عكسية, فكلما زاد عدد الأشياء المعرضة للخطر كلما أدى ذلك إلى جعل معدل الخسائر المقدر قريباً جداً من معدل الخسائر الفعلى وانخفض بذلك الانحراف بينهما مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض في مقدار الخسائر المادية المحتملة .
ج- معدل الخسائر المادية المتوقع :
ويعبر عن قيمة الخسائر المادية المتوقعة لمبلغ ليرة واحدة لقيمة معرضة للخطر لفترة زمنية في الغالب سنة.
ويعتمد أساساً في حسابه على الخبرة السابقة وعلى مدى توافر بيانات تاريخية لفترة سابقة طويلة نسبياً واحتمالات وقوع الحوادث على درجة حدة الخسائر (تسمى متوسط المتوقع = احتمال وقوع الخطر المعرض له الشيئ موضوع الخطر × درجة حدة الخطر (متوسط الخطر لليرة الواحدة) .
الحالة الثانية : قياس الخطر عند شركات التأمين .
الخسارة عند شركة التأمين (الخطر) تنتج من الفرق بين الخسائر المتوقعة والتي على أساسها يتم حساب القسط الصافي والخسائر الفعلية والتي هي عبارة عن المبالغ والتعويضات التي تلتزم بها شركة التأمين لحملة وثائق التأمين, وعلى ذلك فإن:
معدل الخسائر المتوقع = مجموع الخسائر المحققة فعلاً
مجموع مبالغ التأمين
ومن المعروف أن مقدار الخسائر المادية المتوقعة بالنسبة لشركات التأمين إنما يتوقف على عدد العمليات التأمينية التي تتعامل معها الشركة (عدد الأشياء موضوع التأمين) وكما أوضحنا فإن العلاقة عكسية مما دفع العديد من شركات التأمين إلى بذل أقصى جهد للحصول على أكبر عدد ممكن من العملاء .
ويلاحظ أن العلاقة طردية بين معدل الخسائر المتوقعة ومقدار القسط الصافي (التزامات المؤمن عليهم) فكلما زاد هذا المعدل ترتب عليه بالتبعية زيادة في قيمة القسط واجب السداد .
ثانياً: إدارة الخطر والتأمين:
تطور أسلوب العمل في مجال وطبيعة إدارة الخطر والتأمين :
إن الهدف من وجود إدارة التأمين والخطر في الشركات الصناعية والتجارية وغيرها هو الوصول إلى أفضل الطرق في مواجهة بعض المخاطر التي تتعرض لها المنشآت والآلات وحماية الممتلكات والأشخاص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها والتي تؤدي إلى خسائر مادية تقلل من الدخل والثروة, على أن يكون ذلك بأقل تكلفة ممكنة.
ولقد عرفت عملية إدارة الخطر والتأمين منذ فترة طويلة كإحدى الوظائف الهامة في التكوين الإداري وذلك منذ فترة طويلة كإحدى الوظائف الهامة في التكوين الإداري, وذلك منذ أن عرفت وظيفة الأمن بالشركات الصناعية والتجارية, غير أن هذه الوظيفة تقدمت وتطورت ومرت خلال ذلك بمراحل من كان من أهمها الاستعانة بالوسطاء بشركات التأمين للوصول إلى أفضل أنواع الوثائق التأمينية التي تعطي الحماية التأمينية اللازمة والمناسبة للشيئ موضوع التأمين في الزمان والمكان الملائمين.
مرحلة أخرى لهذا التطور وهي التجاء الشركات المساهمة الكبيرة (صناعية أو تجارية ) وخصوصاً في مجال الملاحة البحرية والجوية إلى استحداث أقسام متخصصة للدراسات التأمينية واختيار وثائق التأمين الملائمة والتي تضم عدداً ليس قليلاً من المتخصصين والمهتمين بالعمليات التأمينية لتغطية الحاجات التأمينية لهذه الشركات.
غير أنه مع زيادة حجم الخسائر المادية والتي أصبحت تمثل خطراً كبيراً يهدد هذه الشركات عند وقوعها، تطور أسلوب العمل في هذا الإطار ليمتد ( في مرحلة ثالثة ) إلى دراسة الأنواع المختلفة للمخاطر وطرق المواجهة والمنع والحد من وقوع هذه المخاطر من خلال وضع التقسيمات المختلفة للعوامل المساعدة في وقوع الخطر وعلاقة ذلك بنوعية المخاطر إلى جانب عمل الأبحاث المتعلقة بتحسين طرق قياس احتمال وقوع الخطر وانتشاره ومعدل تكرار وقوع الحوادث والخسائر المتوقعة وما تنطوي عليه من طرق الحد من هذه الخسائر وفي حدود أقل تكلفة ممكنة للأسلوب المستخدم .
ممارسة العمل من خلال إدارة الخطر والتأمين :
تعتبر عملية إدارة الخطر أشمل من عملية إدارة التأمين حيث أن إدارة الخطر يقع عليها أعباء أكثر من مجرد ممارسة الإطار العام للعملية التأمينية المتخذة، فعليها أولاً اكتشاف المخاطر التي تتعرض لها وحدات العملية الانتاجية، ثم محاولة قياس هذا الخطر وتحديد أقصى خسائر متوقعة وأخيراً اختيار الأسلوب الملائم من مجموعة البدائل المتاحة والذي يتناسب مع نوعية الخطر المراد الحماية منه بأقل تكلفة ممكنة ولنا في ذلك التفصيل التالي:
أولاً: عملية اكتشاف الخطر
تعتبر عملية اكتشاف الخطر من أساسيات مسؤول إدارة الخطر ويكون ذلك من خلال جمع المعلومات لفترات زمنية سابقة عن الحالات التي وقع فيها هذا الخطر مع ملاحظة أنه كلما طالت الفترة الزمنية كلما حصلنا على نتائج على درجة عالية من الدقة طبقاً لنظرية الأعداد الكبيرة، إلى جانب عمل تقييم نوعي للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأشياء مع دراسة شاملة تحليلية للعوامل المساعدة والتي قد تساعد في زيادة أو في خفض احتمال وقوع الخطر، وعندما يقع الخطر وتتحقق الخسائر المادية فإنها تساعد في زيادة أو تقليل حجم هذه الخسائر، مع الاهتمام والتركيز على دراسات العوامل التي تحد من فرص وقوع الخطر وتقليل حجم الخسائر المادية.
ويفضل تكوين جهاز فني لذلك يجند له المتخصصون في هذا المجال والقادرون على تطبيق أحدث الطرق والأساليب الرياضية والاحصائية في تحليل البيانات وعمل التدريبات اللازمة لعمال الشركة على كيفية القضاء على أسباب وقوع الخطر والحد من خسائره المتوقعة مع توثيق العلاقة بين هذا الجهاز والإدارات الأخرى في الشركة.
وجدير بالذكر هنا أن وضع دليل للمخاطر وارتباطه بالعوامل لمساعدة ومسببات وقوع هذه المخاطر يعتبر من أهم وظائف إدارة الخطر والتأمين، ومن أكبر العوامل المساعدة في إنجاح هذا العمل.
ثانياً: عملية قياس الخطر
حيث تستخدم في ذلك أحدث الطرق والأساليب الرياضية والاحصائية في تحديد أقصى خسائر احتمالية يمكن أن تتحملها الشركة وذلك من خلال وضع العوامل المحددة لحجم هذه الخسائر في نموذج رياضي يأخذ في اعتباره قيم الأشياء المعرضة للخطر وعدد هذه الأشياء ومعدل الخسائر المتوقعة، ويكون ذلك بطريقة قياسية موضوعية.
ويجب أن نشير هنا إلى ضرورة تبريد المخاطر على حسب درجتها وحجم خسائرها وتصميم التوزيعات الاحتمالية التي ترصد وتفسر لنا حركة هذه المخاطر خلال الفترات الزمنية المختلفة ووضع ترتيب تفاضلي لطرق مواجهة هذه المخاطر من حيث التكلفة لكل أسلوب وما يمكن أن نعطيه من مزايا نسبية.
ثالثا: اختيار الأسلوب المناسب لمواجهة الخطر
ويكون ذلك من خلال ما تم التوصل إليه في مرحلة اكتشاف وقوع الخطر وقياسه حيث أن استخدام الأسلوب العلمي السليم في كشف الخطر وقياسه سيساعد إلى درجة كبيرة في وضع شكل تفضيلي للأسلوب الواجب اتباعه في مواجهة الخطر من حيث التكاليف والمزايا لأنه من المفروض أن الاسلوب الواجب استخدامه هو الذي تقل فيه تكلفة الأسلوب المستخدم عن تكلفة أي أسلوب آخر دون إهمال بعض العوامل الاخرى.
(مازن: يرجى ملاحظة ما كتب باللون الأزرق وتحته خطان لأنه غير مفهوم)