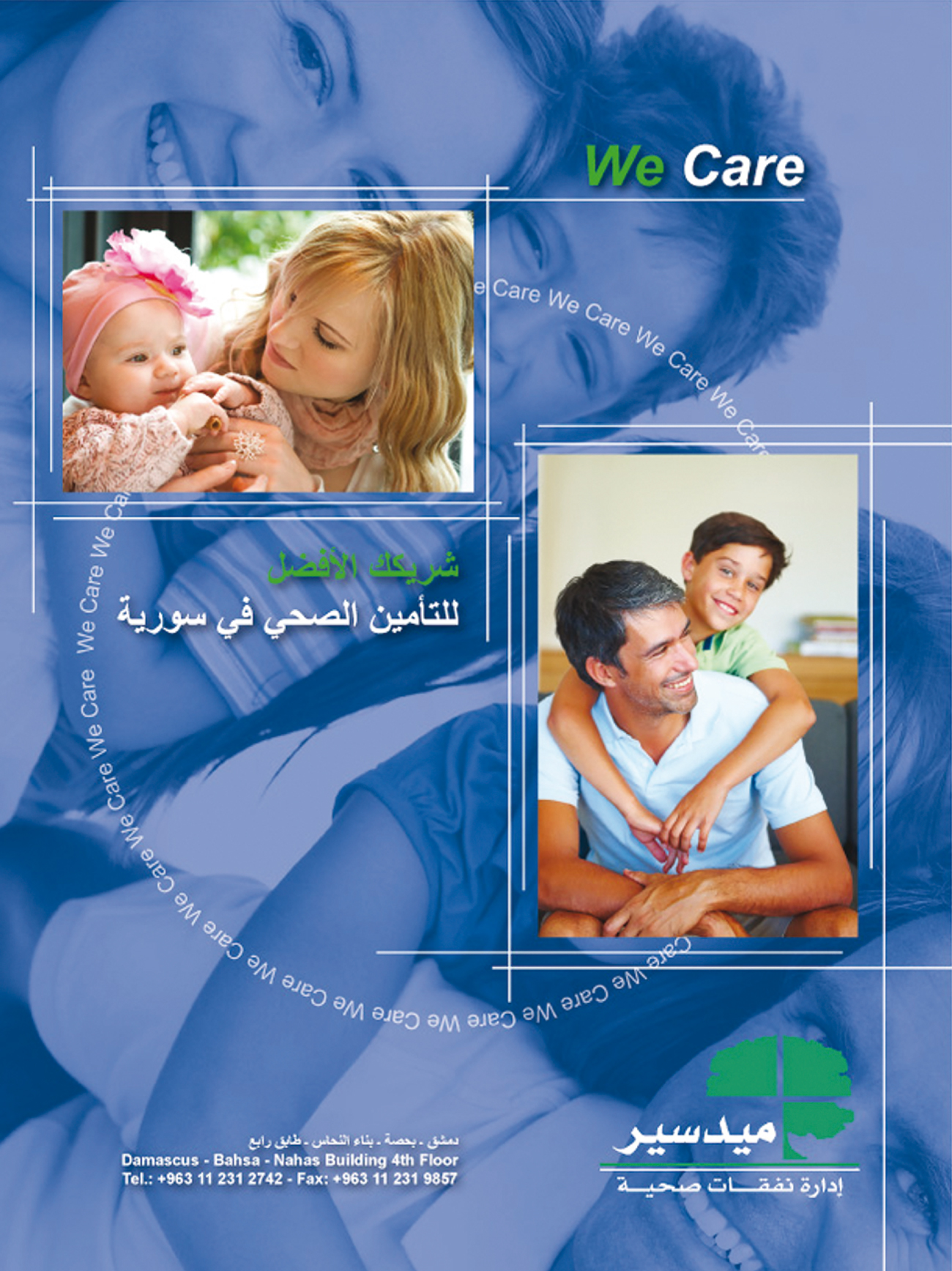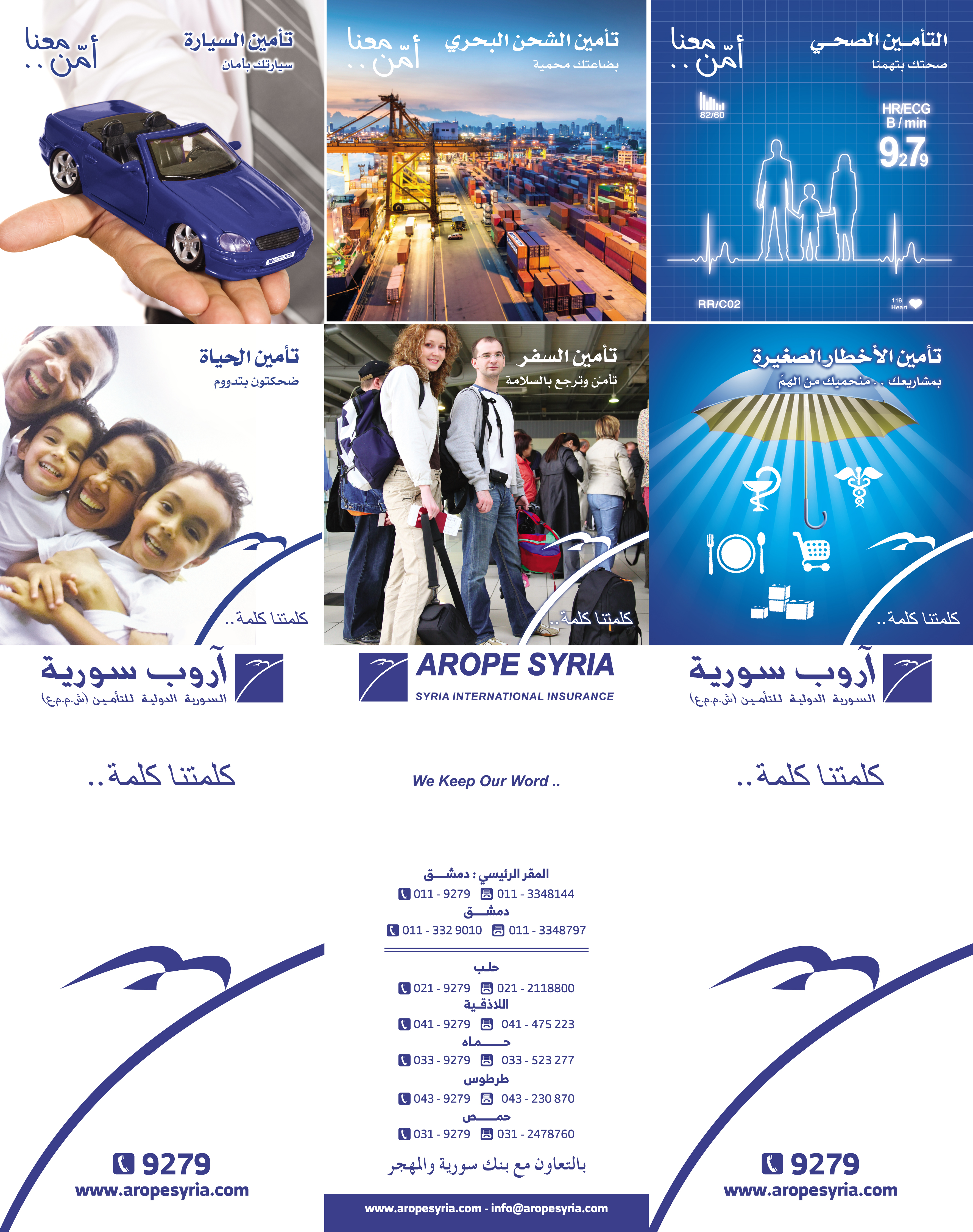بعد مضي عدة سنوات على تطبيق مشروع التأمين الصحي في سورية والذي شمل 750 ألفا من العاملين في القطاع العام الإداري، فإن إعادة تقويم لهذه التجربة تعتبر أكثر من ضرورية سواء لجهة نقاط القوة أم الضعف فيها، سيما ما يتعلق بكفاءة الخدمات الطبية التي تقدمها شركات النفقات الطبية، حيث تسعى الحكومة لتطوير التأمين الصحي عبر توسيع قاعدة المستفيدين منه وزيادة المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة، خاصة وأن البنية التحتية لهذه الخدمات ما زالت دون المستوى، فعدد المستشفيات والكوادر الطبية أقل من أن تخدم الأعداد الكبيرة من المستفيدين الحاليين فضلا عن المرتقبين.
ووضعت اللجنة الوزارية المشكلة لغرض الإشراف على التأمين الصحي والتي تضم ممثلين عن نقابتي الأطباء والمعلمين ووزارتي الصحة والمالية والاتحاد العام لنقابات العمال وهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين ملامح هذا المشروع بكل ما يتعلق به من تغطيات وأقساط واستثناءات وآليات تنفيذ، بينما تولت ست شركات خاصة /رأسمال الواحدة منها 50 مليون ليرة سورية/ تقديم الخدمة.
وتقوم الشركة بدور الشريك الثالث في المشروع بين السورية للتأمين التي تقوم بإصدار عقد التأمين وتغطياته وبين المستفيدين من التأمين، وكذلك بين هؤلاء المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية /الأطباء ودور الأشعة والمخابر والصيدليات والمستشفيات وغيرها/.
وواجهت الشركات خلال هذه التجربة القصيرة بعض المعوقات مع جميع الأطراف إلا أن التنسيق المستمر مع المؤسسة وفروعها أدى إلى حل الكثير منها، ولكن بالرغم من هذه المعوقات تبقى خطوة المؤسسة في القيام بهذا المشروع جيدة وجبارة، حيث يشارك العامل بقسط رمزي بينما تتحمل خزينة الدولة القسط الأكبر، ما أدى إلى تحسين سوق التأمين الصحية بشكل كبير جدا، حيث أصبحت عقودها الخاصة بالمؤسسة تشكل أكثر من 80 بالمئة من مجمل قطاع التأمين الصحي المحلي، لذا يحتاج إلى دعم حكومي للاستمرار وزيادة عدد المشمولين ضمن مظلته.
ويقدم التأمين الصحي مزايا عدة عند المقارنة بين العقود التي تقدمها شركات التأمين الخاصة للمنتفعين في القطاع الخاص وتغطيات القطاع الإداري، حيث يتبين وجود العديد من هذه المزايا لصالح الأخير، رغم أن قسطه السنوي يعتبر أخفض بنحو40 بالمئة من قسط الأول، إذ يتمتع العامل بتغطية الحالات المزمنة والموجودة مسبقا لديه منذ بدء التأمين في حين أن معظم عقود التأمين الخاصة لا تقدم هذه الميزة إلا بعد مرور السنة الأولى، وقد تضع بعض الحدود المالية لتغطية هذه الحالات.
كما أن معظم عقود التأمين الخاصة تضع حدا أعلى لاستخدام التأمين الصحي ضمن المستشفى قد يكون 5-10 ملايين ليرة سورية سنويا، في حين أن هذا الحد غير موجود في القطاع الإداري، أما موضوع الحد الأعلى للحالة، فهو 300000 ليرة في القبول الواحد، علما بأن الحالات التي تحتاج إلى أكثر من هذا المبلغ قليلة جدا أو معدومة تقريبا.
كذلك، فإن معظم الاستثناءات الموجودة في عقد الإداري تشاهد في العقود الخاصة (عدم تغطية الحالات التجميلية) الحالات الخلقية (الأمراض النفسية، المشاركة في أعمال العنف والإرهاب، الأدوية العشبية والمتممات الغذائية)، وهذا الأمر يطبق في أغلب عقود التأمين حول العالم، أما بالنسبة لتغطية المعالجة السنية فإن معظم عقود التأمين الخاص تطلب قسطا إضافيا لتغطية هذه المعالجة، ورغم ذلك تبقى هذه التغطيات محصورة بحد مالي وخدمات محددة.
وظل التأمين الصحي منذ انطلاقة قطاع التأمين في سورية عام 2006 ضعيفا جدا، حيث أنه قبيل بدء المشروع منتصف عام 2010 ، أي بعد مرور أربع سنوات على بدء العمل لم يكن العدد الإجمالي للمستفيدين من عقود التأمين الصحي يتجاوز100 ألف مؤمن من أصل 23 مليون نسمة أي بنسبة لا تتجاوز 4ر0 بالمئة من مجموع السكان نتيجة عدة عوامل أبرزها.. ضعف الوعي التأميني وعدم قيام شركات التأمين الخاصة بالتركيز في نشاطها التسويقي على هذا النمط من التأمين، ومع بداية المشروع تزايد هذا العدد ليبلغ نحو مليون شخص تقريبا أي زيادة النسبة إلى أربعة بالمئة.
إنطلاق مشروع تأمين العاملين في الدولة:
بعد تعثر صدور قانون الضمان الصحي الذي بقي الشغل الشاغل للسوريين لعدة سنوات، وجدت الحكومة أن مشروع التأمين الصحي المقترح من قبل وزير المالية قد يكون رديفاً أو بديلاً عنه.
وضعت الخطط لتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى : تأمين العاملين في القطاع الإداري للدولة وعددهم ما يقارب 600000عامل (لا يملكون أي تغطية صحية باستثناء مساهمات بسيطة قد تقدمها الصناديق التعاونية في بعض الجهات)، وقد تم تنفيذ كامل هذه المرحلة تقريباً
المرحلة الثانية : تأمين المتقاعدين حيث صدر المرسوم التشريعي /46/ لعام 2011 القاضي بتأمين المدنين والعسكريين منهم، إذ تتحمل خزينة الدولة 62.5% من القسط التأميني بينما يتحمل المتقاعد 37.5%.
المرحلة الثالثة: تأمين عائلات العاملين
بدأ العمل بالمرحلة الأولى من المشروع وفق الخطوات التالية:
- صدر المرسوم التشريعي /65/ لعام 2009 الذي يتيح للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحي للعاملين لديها مع المؤسسة.
- أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مهمتها تحديد الإطار التنظيمي والتنفيذي لتنفيذ المشروع.
- قامت المؤسسة بالتعاقد مع ست شركات لإدارة النفقات لتكون قادرة على تخديم هذا العدد الكبير من المؤمنين.
آلية عمل الشركات:
يصدر عقد التأمين بكافة استثناءاته وتغطياته وحدوده المالية (سقوف التغطية) عن الشركة، ويتم إرسال هذا العقد إليها لتقوم بإدارته (أي ان شركة الإدارة لا علاقة لها بالاستثناءات وحدود التغطية، بل تردها جاهزة من شركة التأمين)، حيث تقوم شركة الإدارة بإدخال هذه الشروط والتغطيات ومعلومات المستفيدين في نظام معلوماتي خاص، بحيث يصبح لكل مستفيد (مؤمن) سجلاً خاصاً به.
تقوم الشركة بإنشاء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية تغطي جميع المناطق الجغرافية حسب عقود التأمين الحاصلة عليها، حيث توقع عقوداً مع جميع مقدمي الخدمة هؤلاء، وتوضح هذه العقود حقوق وواجبات كل طرف، مع التسعيرة التي يتم الاتفاق عليها (وعادة ما تكون حسب الحد الأعلى لتسعيرة وزارة الصحة)، وهناك بعض الإجراءات الخاصة تحتاج عادة إلى موافقة مسبقة قبل إجرائها، ويمكن له الحصول عليها بسرعة (عادة خلال 10 – 15 دقيقة) عبر نظام online.
كذلك تقوم الشركة بدراسة الحالات الطبية التي تراجع مقدمي الخدمات، وذلك حرصاً على أن يحصل المؤمن على الخدمة الطبية اللازمة والضرورية فقط، وتعتمد في ذلك على فريق من الأطباء المختصين العاملين ضمن مكاتبها، والذين يعتمدون في قراراتهم الطبية على المعايير العالمية، بحيث تمنع إجراء الخدمات الطبية غير اللازمة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على صحة المريض، أو أن تكون غير ضرورية لحالته الصحية.
تقويم المشروع وتطوير العمل:
لقد خطت المؤسسة خطوة جبارة في المباشرة في هذا المشروع الذي سبقت فيه العديد من البلدان المجاورة في تأمين العناية الطبية الضرورية للعاملين في الدولة مقابل مشاركة العامل بقيمة رمزية من القسط.
المعوقات والمشكلات:
إن البدء بمشروع جديد يترافق دوماً مع بعض المعوقات التي يمكن التغلب عليها لإنجاح المشروع، ومنها:
1. عدم معرفة المؤمن بشروط التأمين وتغطياته وحدوده، ما أدى إلى حدوث بعض المشكلات عند رفض تغطية بعض الحالات غير المرتبطة بالتشخيص أو التي لا يغطيها التأمين.
2. قيام بعض مقدمي الخدمات بالإساءة (عن قصد أو عن غيره) للمشروع، عبر عدم استقبال المنتفعين لسبب أو لآخر، (مع أن الحق يكون غالباً على الطبيب لأنه لم يفهم دوره بشكل واضح في هذه المعادلة، ومازال يعتبر أن التأمين هو وسيلة لتحقيق كسب إضافي).
3. نقص الوعي التأميني عند العديد من الأطراف، بخاصة المؤمنين ومقدمي الخدمات، وأعتقد أن الإعلام يتحمل جزءاً من هذا التقصير، بسبب عدم التركيز على نشر الوعي والثقافة التأمينية، وتتوقع الشركات من الإعلام والإعلاميين دوراً مهما في دعم المشروع.
4. ضعف البنية التحتية الخاصة بالاتصالات، ما يمنع مقدمي الخدمات من التواصل عبر الانترنت مع الشركة، ويقلل من جودة عمل النظام معلوماتيا.
5. عدم التزام بعض مقدمي الخدمة بالعمل بالأسلوب الصحيح ومحاولة عرقلة المشروع لعدة أسباب، وهنا يبرز دور المؤمن في إبلاغ مقدم الخدمة غير الملتزم ليتم التعامل معه.
6. عدم فهم المؤمنين لحقوقهم وواجباتهم، ومحاولة التحايل عليه أحياناً لتغطية خدمات طبية لا يغطيها التأمين.
7. محاولة بعض المؤمنين الاستفادة من البطاقة لمعالجة أقاربهم وآخرين.
8. هناك أمور مطلوبة من بعض قطاعات الدولة تزيل بعض العقبات وتحسن من الأداء، مثل:
-استياء المؤمن من أخذ علب الدواء الفارغ (أو جزء منه) من قبل الصيدلي وإرسالها إلى شركة التأمين عن طريق شركة الإدارة لعدم وجود وسيلة ضبط بديلة تمنع الصيدلي من تبديل الأدوية بمستحضرات أخرى ما قد يتسبب في هدر كبير في الانفاق. ويحل عبر اسراع وزارة الصحة بترميز علب الدواء (باركود) وهي أفضل الطرق وأكثرها حضاريةً في التنظيم والضبط.
-وجود اختلاف في التسعيرة المتفق عليها من قبل الشركات مع المشافي. ويحل بإصدار الوزارة التعليمات الخاصة بتصنيف المشافي.
-افتقار التسعيرة الحالية الصادرة عن نقابة الأطباء إلى تسعير العديد من الإجراءات الطبية، ويحل باعتماد الوزارة والنقابة التسعيرة الجديدة التي تغطي جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يحتاجها المريض.
*إعلامي اقتصادي
ثقافة تأمينية
جديدها وجادتها.. ظلال تجربة التأمين الصحي في سورية